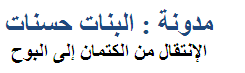في الأزمنة المرتبكة كزماننا ، والعوالم الخطرة كعالمنا ، تغدو الجغرافيا المحيطة
ترفاً ، وعلم الإجتماع يُصبح
مكملاً ثقافياً يمكن أن ينتظر قليلاً أو كثيراً ، فالكون بخريطته البائسة ،
وخبيئته المريبة ، لن يكون بوسعه أن يقدم لك تبريراً مقنعاً ، لاسيما إذا ما تداخلت
لديك خطوط الطول والعرض ، بفعل الكوميديا السوداء ، التي هي على مرمى حجر منك ،
أينما وليت وجهك عاينت طرفاً لها ، حتى وإن لم تكن جزءاً منها ، فالشرر وإن كان
يصيب اللاعبين بالنار حتماً ، فإنه ينال بشكل أو بآخر أيضاً من أولئك الأبرياء الذين
ما أشعلوا في حياتهم عود ثقاب .
صليل
الصوارم ، يُعزف بتوزيع جديد هذه المرة ، يصك
آذان السامعين الآمنيين بفرنسا ، ويُحيل الليل الباريسي الناعم ، إلى مواكب يختلط فيها
صوت الموت مع نداء الإستغاثة ، وصوت الموسيقى مع صراخ عربات الإسعاف التي تريد أن
يُفسح لها الطريق ، الرؤوس التي تعودت أن تميل طرباً ، مالت ميلتها الأخيرة ، بعد
ان زرعت البداوة نبتتها الجافة في عاصمة كل ذنبها ، أنها فرحة ومرحة .
لعل
أحد أهم وأخطر التعليقات من الداخل الفرنسي بعد هذا العمل الإرهابي الذي ضرب
العاصمة باريس يوم الجمعة الماضية ، ما قيل أنه على فرنسا ، عدم الركون - من الآن -
لفكرة كونها عاصمة النور ، أو البقاء على حالة الإسترخاء الليبرالي بوضعيته الراهنة ، الأمر الذي
يعني أن تتحلل هذه المدينة التاريخية العظيمة ، ولو إلى حين ، من بعض بهاءها لحساب
إجراءات إستثنائية فرضتها أجندة من هم على خصام دائم مع الحضارة .
 |
| رينه سولي برودوم |
أعادتني الأحداث المريرة إلى الوراء ، وتحديداً لحقبة الدراسة الثانوية ، حيث بدا لي أحد معلمي اللغة الفرنسية ، كأنه نبيل حقيقي ، أو أرستقراطي تحدر من تلك
الطبقة المخملية ، التي كانت تحكم في حقبة ما قبل الثورة الفرنسية ، وأذكر كم كنت
أنظر إليه بعين مليئة بالإكبار والإعجاب ، ذلك أنه لم يكن معلماً تقليدياً للغة
أجنبية فحسب ، بل حسبته غارقاً أو مستغرقاً في الفرنسية كأنها لغته الأم ، فمن خلف
نظارته الطبية ، ووسامته التي كانت بادية للعيان ، تجاوز الرجل كل الحدود
التقليدية لمنهج دراسي عقيم ، فقد كان يطوف بنا كل أرجاء فرنسا ، من خلال شوارعها
الضيقة ، وعاين معنا الشرفات التي كانت تطل على الثوار وهم يتجهون لإقتحام سجن
الباستيل ، كيف لي أن أنسى وهو ينصب خيمته على مقربة من خيام كل أولئك النفر الذين
جعلوا من باريس عاصمة حقيقية للنور ، فيعطينا طرفاً من متعة جار هنا ، وطرفاً من
إثارة جار هناك ، أشار مدرسنا بيده ذات مرة لذاك النابغة ، الذي صك مقولته الخالدة ( أني أختلف معك في رأيك ، ولكنني مستعد أن أموت دفاعاً ، من أجل حريتك في التعبير عنه ) ، كان هذا فولتير .
في كلية الحقوق ، كانت إحدى
المواد المحببة لديًّ هي مادة (النظم السياسية والقانون الدستوري) ، حيث
يًعنى هذا العلم بعرض لنظم ونظريات الحكم قديماً وحديثاً ، مع عرض الإتجاهات
المختلفة الخاصة بوضع الدساتير التي هي الرباط الحاكم ، أو الناظم للعلاقة
بين الحاكم والمحكوم ، وأذكر هنا أن تصدر أحد الفصول ، عبارة مقتبسة ومنسوبة
للملك الفرنسي لويس الرابع عشر ، المعروف بالملك الشمس ، والتي يقول فيها (أنا
الدولة ، والدولة أنا) ، وحيث أنني لديِّ بعض الميول الديكتاتورية لسبب غير
معلوم لي للآن ، فقد إهتممت بهذه المقولة أيما إهتمام ، غير أن تتبعي لقائلها ،
أتاح لي إكتشاف زوايا جديدة له ، ففي رسالته مثلاً لأحد أحفاده الذي كان يستعد للمغادرة
ليصبح ملكاً على أسبانيا ، قال له لويس الرابع عشر :-
( لا تقرب أبداً أولئك الذين
يزيدون في تملقك ، ولكن تمسك عوضاً عن ذلك بهؤلاء الذين يغامرون بإزعاجك من أجل
مصلحتك ، ولا تهمل عملك أبداً لمصلحة متعتك ، نظم حياتك حتى يصبح فيها وقت
للإسترخاء والتسلية ، أعط أمور الحكم كل إنتباهك ، ثقف نفسك قدر المستطاع قبل إتخاذ
أي قرار ، إعمل كل ما في وسعك لتتعرف على الرجال المتميزين ، بحيث تتمكن من
الإستعانة بهم متى إحتجت إليهم ، كن مهذباً مع الجميع ، لا تُسئ لأي إنسان ) .
في الختام .. وبعيداً
عن الفتنة الباريسية ، وكل ألق مستحضرات التجميل ذائعة الصيت ، والعطور الفاخرة ، وعروض
الأزياء ، بعيداً عن قوس النصر والشانزليزيه ، بعيداً حتى عن قصر فرساي ، بعيداً عن كل الأيقونات المضيئة ، فأنا كغيري مدينٌ شخصياً لهذه المدينة بالكثير ، مدين لها بكل ما قرأته لثلة من أبناءها البررة
، الذين ساهموا عبر السنين ، ولا يزالون في تشكيل الوعي والوجدان الإنساني في كل
حقل ومضمار ، مدين لأقلام أدبائها العظام وفلاسفتها النوابغ ، الذين علمونا ولا
يزالون كيف يعمل العقل ، وكيف يكون الجدل ، ما هو التسامح ، والعدل ، والإخاء ، والمساواة ، لذا فأني أعتذر لهذه المدينة التي أهان جمالها أجلاف من البادية ، كل زادهم تراثٌ يفوحُ من رائحته البارود .